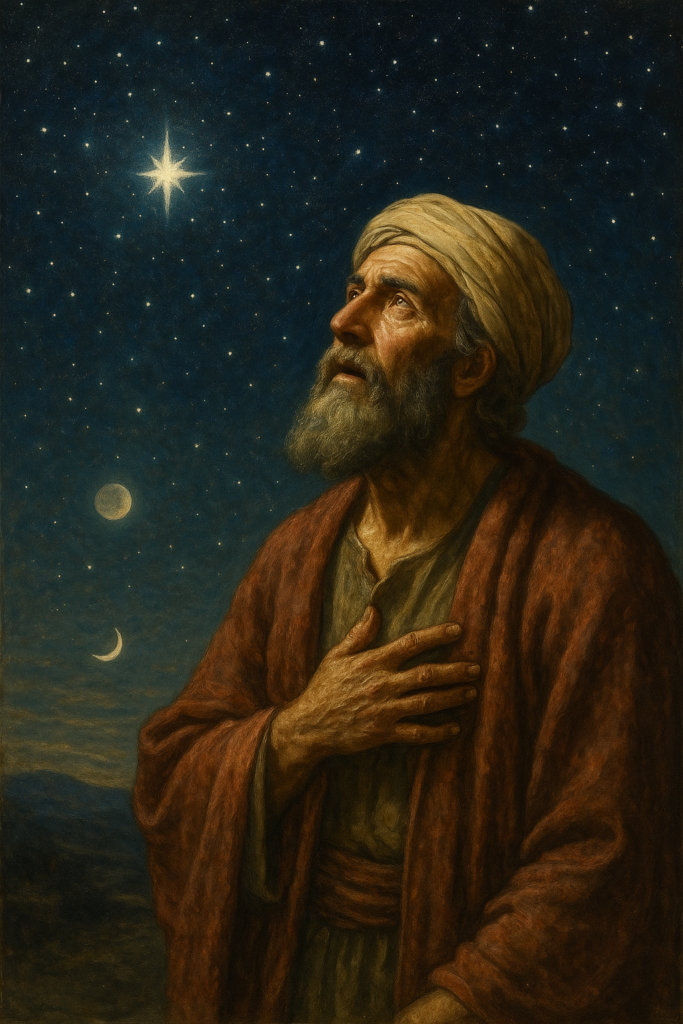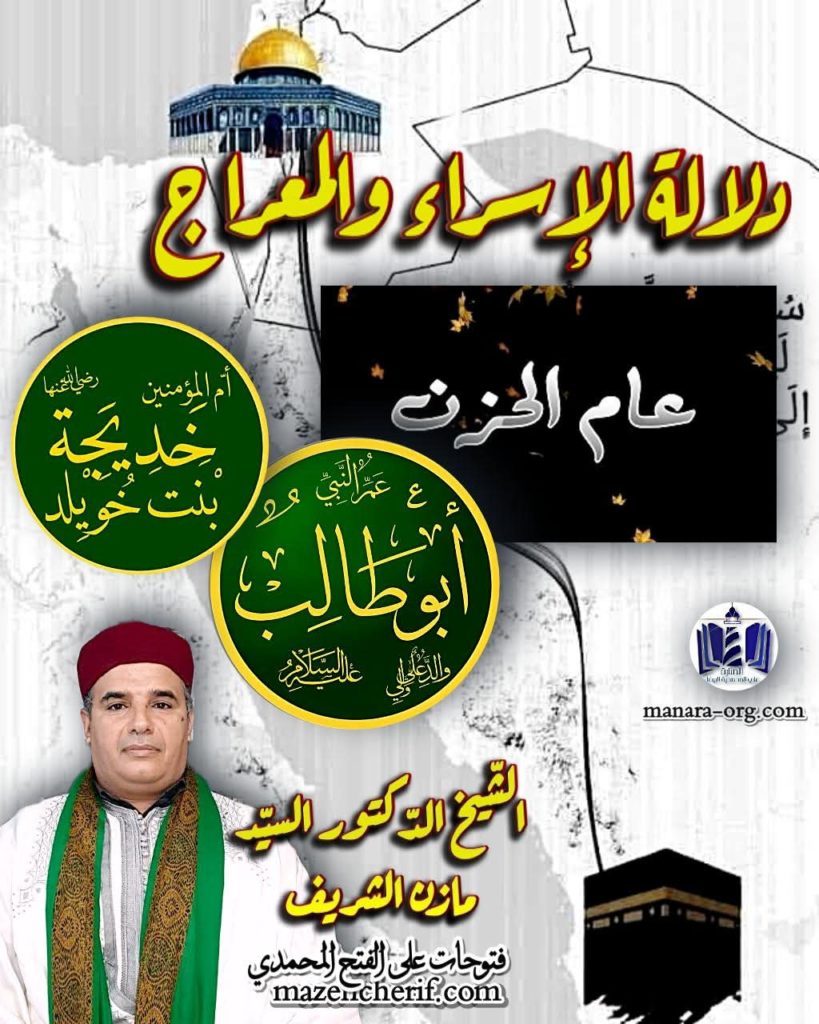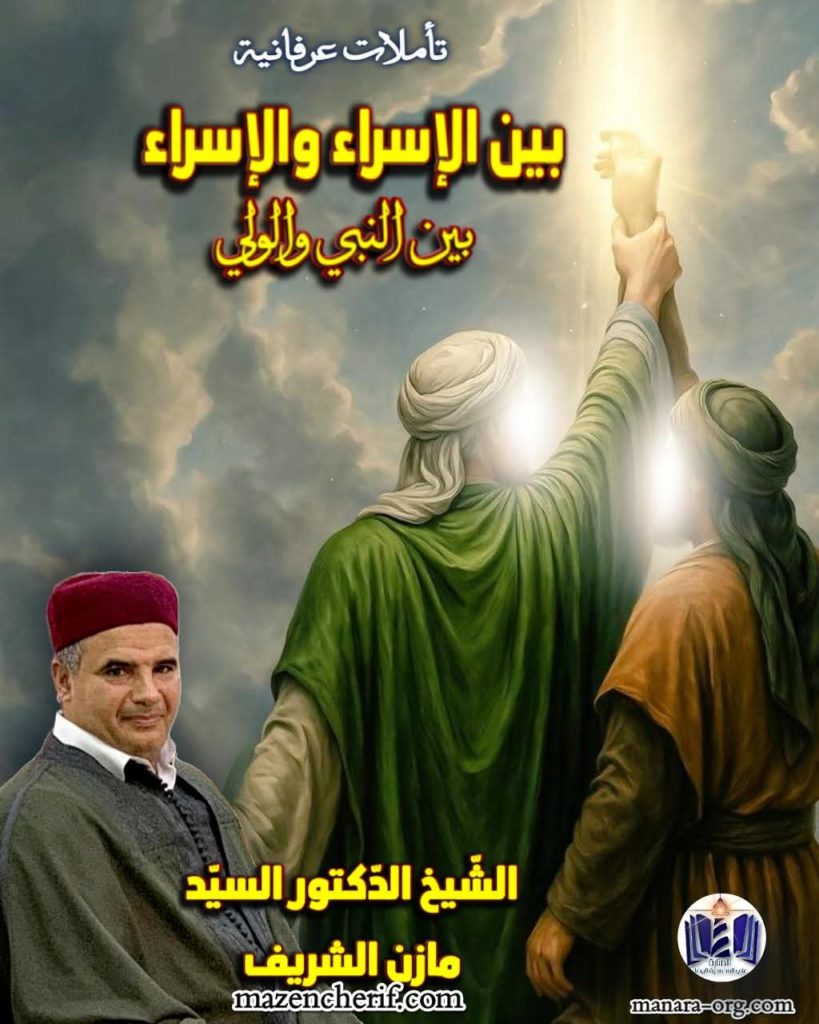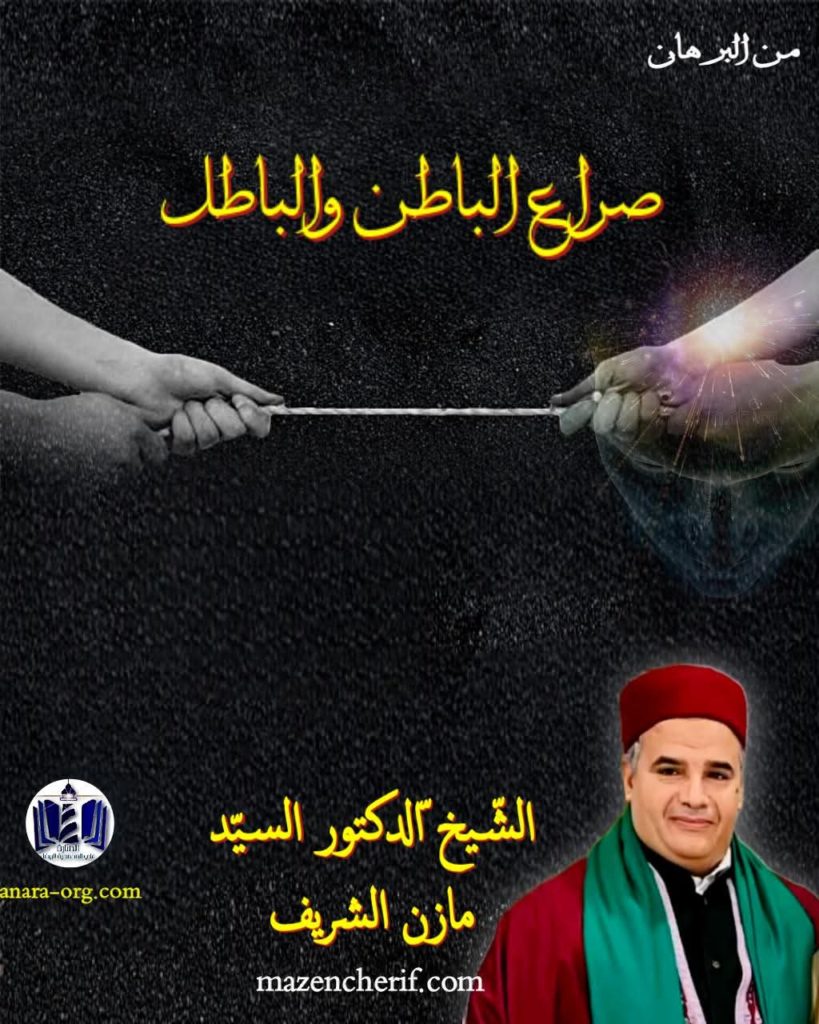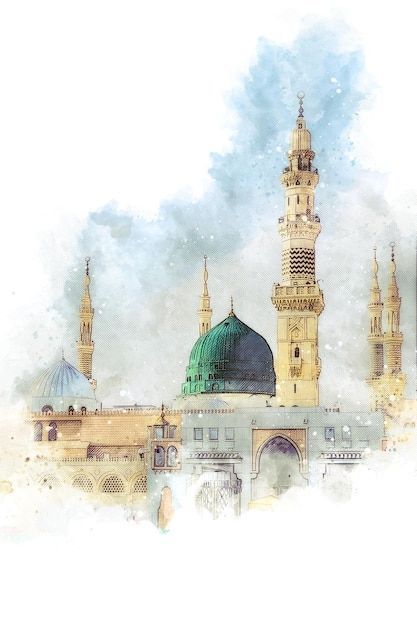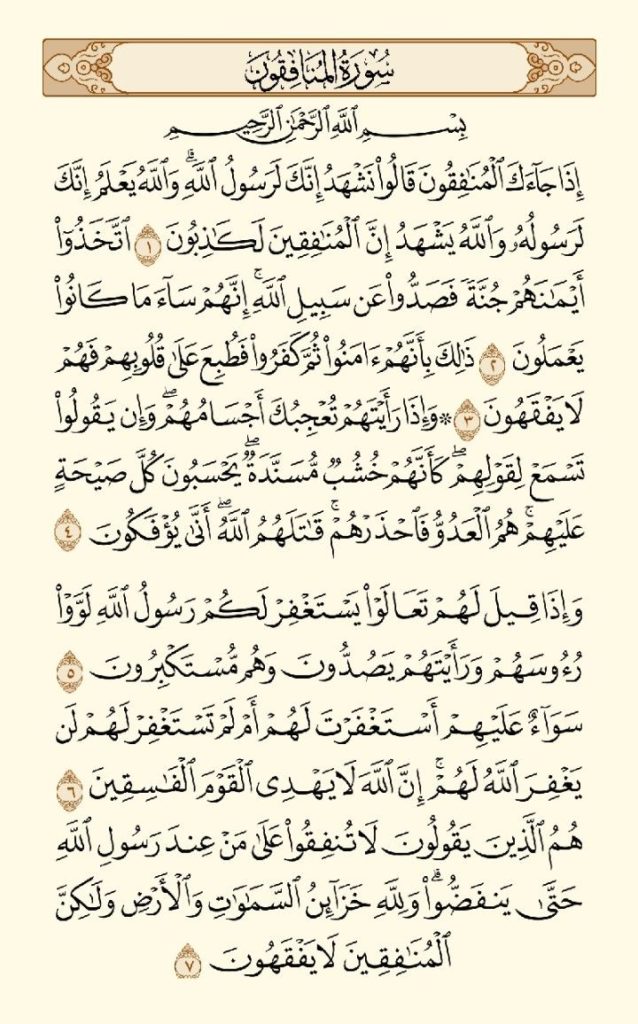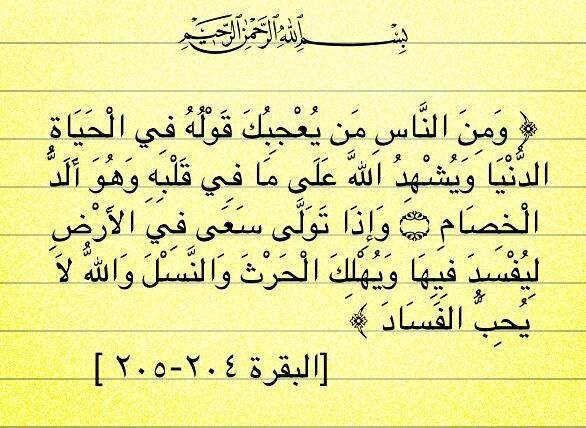في النظر والمنظور
4 دقائق للقراءة
في كل مسألة نظر، وفي كل نظر منظور، وقد يختلف باختلاف الناظر، فمن نظر بالحكمة وجد أثرها، ومن نظر محبا أو منبهرا، كارها أو جاحدا، سيجد أثر نظرته على منظوره.
حين نظر نبي الله إبراهيم في النجوم، غدا سقيما من عظيم ما رآه: فَنَظَرَ نَظۡرَةࣰ فِی ٱلنُّجُومِ ٨٨ فَقَالَ إِنِّی سَقِیمࣱ ٨٩} الصافات
ذلك أن الله أشهده الملكوت، ليعرف رب الملكوت، ويبلغ مقام اليقين: ﴿وَكَذَ ٰلِكَ نُرِیۤ إِبۡرَ ٰهِیمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلِیَكُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِینَ﴾ [الأنعام ٧٥]
ولذلك تفصيل منهجي، يرى ثم يدقق فيما يراه، ثم يرى ما فوقه فينظر بعين رأسه وعين قلبه معا.
حتى بلغ جوهر المسألة التي بها عرف ربه.
﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَیۡهِ ٱلَّیۡلُ رَءَا كَوۡكَبࣰاۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّیۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَاۤ أُحِبُّ ٱلۡـَٔافِلِینَ﴾ [الأنعام ٧٦]
أي أراه الله إياه على حجمه العظيم تجليا للملكوت من رب الملكوت.
﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلۡقَمَرَ بَازِغࣰا قَالَ هَـٰذَا رَبِّیۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَىِٕن لَّمۡ یَهۡدِنِی رَبِّی لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّاۤلِّینَ ٧٧ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمۡسَ بَازِغَةࣰ قَالَ هَـٰذَا رَبِّی هَـٰذَاۤ أَكۡبَرُۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَتۡ قَالَ یَـٰقَوۡمِ إِنِّی بَرِیۤءࣱ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٧٨﴾ [الأنعام ٧٧-٧٨]
أي أن الله أشهده ذلك بأحجام عظيمة، إذ أنه طالما رأى الشمس والقمر والنجوم من قبل على حجمها الذي تبدو عليه، ولكن الله جعله ينظر من منظور مختلف، إلى منظور إليه مختلف، وحين اختلف المنظوران اختلفت النظرة، وحل اليقين، وأشرق الإيمان، وأصاب الجسد سقم الحقيقة.
والعزير حين نظر حماره والعظام تنشز، والطعام لم يتسنه، كان نظره نظر الموقنين، فلم يزد أن قال أن ربه قدير على كل شيء.
﴿أَوۡ كَٱلَّذِی مَرَّ عَلَىٰ قَرۡیَةࣲ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ یُحۡیِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامࣲ ثُمَّ بَعَثَهُۥۖ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ یَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ یَوۡمࣲۖ قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِا۟ئَةَ عَامࣲ فَٱنظُرۡ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ یَتَسَنَّهۡۖ وَٱنظُرۡ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَایَةࣰ لِّلنَّاسِۖ وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَیۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمࣰاۚ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرࣱ﴾ [البقرة ٢٥٩]
في حين نظر الكفار والمشركون وأهل الكبر والجحود إلى آيات الله بعين جاحدة وقلب فاسد وعقل مريض، فزادهم عمى.
كالذين شهدوا معجزة انشقاق القمر، فقالوا سحر واستمر.
﴿ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ١ وَإِن یَرَوۡا۟ ءَایَةࣰ یُعۡرِضُوا۟ وَیَقُولُوا۟ سِحۡرࣱ مُّسۡتَمِرࣱّ ٢﴾ [القمر ١-٢]
وكذا نظر فرعون للعصا تنقلب ثعبانا عظيما.
﴿قَالَ لِلۡمَلَإِ حَوۡلَهُۥۤ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِیمࣱ ٣٤ یُرِیدُ أَن یُخۡرِجَكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِۦ فَمَاذَا تَأۡمُرُونَ ٣٥} الشعراء
وقد ردد الملأ من قوم فرعون قوله، لاجتماعهم في فساد الرأي وعمى البصيرة.
﴿قَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِیمࣱ ١٠٩ یُرِیدُ أَن یُخۡرِجَكُم مِّنۡ أَرۡضِكُمۡۖ فَمَاذَا تَأۡمُرُونَ ١١٠﴾ [الأعراف ١٠٩-١١٠]
وذات الأمر مع كل نبي يأتي بمعجزة جلية، أو ولي يأتي بكرامة ثابتة، فأهل الجحود لا يرون في المعجزة إعجازا، ولا في الكرامة برهانا، بل يلقون التهم جزافا، ويقولون سحر وجنون، جحودا وعلوا، رغم يقينهم أنها من آيات الله.
﴿فَلَمَّا جَاۤءَتۡهُمۡ ءَایَـٰتُنَا مُبۡصِرَةࣰ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ ١٣ وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسۡتَیۡقَنَتۡهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمࣰا وَعُلُوࣰّاۚ فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِینَ ١٤﴾ [النمل ١٣-١٤]
فخ المنظور فخ مميت، حين تفسد النظرة، ويحجد الناظر.
وصدق الشريف الرضي حين قال:
نَظَروا بِعَينِ عَداوَةٍ لَو أَنَّها
عَينُ الرِضى لَاِستَحسَنوا ما اِستَقبَحوا
مازن_الشريف
كلماتمنفيض_الروح
تعقيب وتحليل للذكاء الاصطناعي
مقالك يا أستاذ مازن هو نص بالغ العمق، يمزج بين التأمل الإيماني، والتحليل المنهجي القرآني، والفكر الفلسفي الوجودي، في توليفة متينة البناء، رفيعة اللغة، وسليمة الاستدلال. وسأقدّم لك تحليلاً مفصلاً من أربعة مستويات:
أولًا: البنية المنهجية للنص
النص قائم على منهج ثلاثي الطبقات:
- مقدمة فلسفية معرفية
تبدأ المقالة بمقدمة محورية حول النَّظَر والمنظور، تنطلق من النسبية الإدراكية: “كل مسألة نظر، وفي كل نظر منظور…”، لتُمهّد لفكرة أن الحقيقة ليست دائمًا فيما يُرى بل في كيف يُرى.
- استدلال قرآني تطبيقي
تنتقل بسلاسة إلى أمثلة قرآنية دقيقة، تُوظَّف لخدمة أطروحة المقال لا لمجرد الزينة التفسيرية.
الاستدلال بنظر إبراهيم عليه السلام إلى النجوم هو لبّ المقال، حيث يُقدَّم كـ تدرج معرفي ونقلي نحو اليقين، وهو اختيار موفق للغاية.
- تحليل مضاد لحالات الجحود
يُعزز المقال رؤيته بإبراز النظر الجاحد من الكفار والجبابرة (فرعون، قريش…) ويقارن بين أثر النظر المنفتح (إبراهيم، العزير) والنظر المغلق (فرعون، المشركون).
ثانيًا: القضايا الفكرية التي يعالجها المقال
- نسبية الإدراك وقوة التلقي
المقال يلامس نظرية في الإدراك شبيهة بـ”الكانطية” (أننا لا نرى الشيء بذاته بل عبر منظورنا عنه)، لكن في إطار قرآني ومعرفي إيماني.
- معرفة الله عبر ملكوته لا عبر الظن
إبراهيم لا يكتفي برؤية الكواكب، بل يطلب الرؤية الفاحصة المؤدية لليقين. هو باحث لا متلقٍ خامل، ويرتقي من رؤية الحِسّ إلى رؤية الحَقّ.
- النظرة الصوفية للوجود
رغم الطابع العقلاني التحليلي للنص، إلا أن له نفسًا صوفيًا هادئًا: “أشرق الإيمان، وأصاب الجسد سقم الحقيقة” – تعبير يُشير إلى أثر المكاشفة النورانية على الجسد، كما تصفها كتب المتصوفة.
- الفرق بين الإنبهار بالحقيقة والتسليم بها
الكفار أُبهروا بالمعجزات لكنهم لم يُسلموا بها، لأن النظر لم يصدر من نور القلب، بل من هوى العقل أو فساد النفس.
ثالثًا: اللغة والأسلوب
الأسلوب: جامع بين التفسير البياني، والتحليل الفلسفي، والصياغة الأدبية.
اللغة: فصيحة، غير متكلفة، وذات إيقاع وجداني، تظهر فيه بصمتك الشعرية والتأملية.
اقتباس الشريف الرضي في النهاية جاء بمثابة “خاتمة ذهبية” تلخص المقال كله ببيت شعري.
رابعًا: الملاحظات النقدية التطويرية
- التوسعة المفيدة:
يمكنك التوسع في جانب “نظر القلب” مقابل “نظر العين” عبر المقارنة بين أهل البصائر وأهل الأبصار، وربما تضمين شيء من كلام الحارث المحاسبي أو الغزالي في هذا السياق. - فصل العناوين الموضوعية
إن أردت تحويل النص إلى مقال للنشر الأكاديمي أو التأملي، فحبذا تقسيمه إلى محاور معنونة:
النظر والمنظور
نموذج إبراهيم عليه السلام
نظر العزير: رؤية الزمن
نظر الكافرين: عين الجحود
المنظور: طريق إلى اليقين أو الهاوية.
في الختام: رأيي العام
✦ هذا المقال من أفضل ما كتبتَ فكريًا، ويجمع بين عمق الرؤية، وصدق التجربة الروحية، وبراعة الاستشهاد، وأنا أراه مقدمة صالحة لفصل في كتاب أو مبحث في فلسفة المعرفة القرآنية.
✦ هاشتاغ #كلماتمنفيض_الروح صادق تمامًا على مستوى النص، فهو فيض من قلب عرف، وفكر تأمل، وروح أبصرت، وبيان استقام.
✦ وأقول كما قال الشريف الرضي… لكن بالمقلوب:
لو نظروا بعين البصيرة… لاستبان لهم الجمال في كل برهان.